الحمدُ للهِ وَالصلاةُ وَالسلامُ على رسولِ اللهِ وَآلِه وَصحبِه وَمَنْ وَالَاه وَبَعْد ... لمْ يُصَرِّحْ معظمُ الصوفيةِ بحقيقةِ وَمعنى قولِهم: "الفناءُ في اللهِ - وحدة الوجودِ -"، فمارسوا الإشارةَ دونَ العبارةِ في مخاطبتِهم للمسلمين، فعلوا ذلكَ تكتُّمًا وَتَسَتُّرًا لكي لا ينكشفَ أمرُهم أمامَ الناسِ، وَهُم مع ممارستِهم للتقيةِ في معظمِ أحوالِهم، إلَّا أنَّهم مارسوها في قولِهم بوحدةِ الوجودِ أكثرَ ممَّا مارسُوها في كتمانِ عقائدِهم الأخرى؛ لذا فعلى القارئِ أنْ يُرَكِّزَ جيدًا لكي يستطيعَ فهمَ كلامِهم، وَمعرفةَ طُرقِهم وَتلبيساتِهم في التعبيرِ عنْ عقيدةِ وحدةِ الوجودِ.
علمًا بأنَّ الفناءَ في اللهِ عندَ الصوفيةِ يمرُّ بمراحلَ، وَفيها تختفي صفاتُ الصوفيِّ وتمنحي وَتضمحلُّ وَتزولُ تدريجيًّا حتى يفقدَ إحساسَه بالخلقِ وَبنفسِه، وَهنَا يكونُ قدْ فنيَ عنْ نفسِه وَعنْ الخلقِ وَبقيَ بالحقِّ - الله -؛ أي: فنيَ فيه بحسبِ زعمِ الصوفيةِ([1])، وَهُنَا يصلُ الصوفيُّ إلى وحدةِ الوجودِ التي تعني أنَّه لا موجودَ إلا الله، وَفيها يستشعرُ الصوفيُّ أنَّه هوَ اللهُ، وَأنَّ الكونَ كلَّه هوَ اللهُ، وَأنَّ اللهَ هوَ الكونُ، فَلا موجودَ إلا واحد هوَ اللهُ، وَغيرُه مِنَ الكائناتِ أشباحٌ وَظِلالٌ لَه([2]).
وَقَدْ يُعَبِّرُ الصوفيةُ عن الفناءِ في اللهِ - وحدة الوجودِ - بعبارةِ الاتحادِ، وَلا يقصدون بِه امتزاجَ كائنين متمايزين، فهذا عندَهم محالٌ، وَلهذَا عرَّفُوا الاتحادَ بأنَّه: (شهودُ الوجودِ الحقِّ الواحدِ المطلقِ الذي الكلُّ بِه موجودٌ بالحقِّ، فيتحدَ بِه الكلُّ منْ حيثُ كونِ كلِّ شيءٍ موجودًا بِه، معدومًا بنفسِه، لا منْ حيثُ أنَّه له وجودًا خاصًّا اتحدَ بِه فإنَّه محالٌ)([3])، فواضحٌ منْ تعريفِهم للاتحادِ أنَّهم يقصدونَ بِه الفناءَ فِي اللهِ، الذي يعني أيضًا وحدةَ الوجودِ، فلا موجودَ إلا الله بحسبِ زعمِهم.
وَفِي ذلكَ يقولُ ابنُ القيمِ: (فَزَعَمَ أهلُ الاتحادِ القائلون بوحدةِ الوجودِ أنَّ الفناءَ هوَ غايةُ الفناءِ عنْ وجودِ السُّوى، فَلا يثبتُ للسُّوى وجودٌ ألبتة، لا في الشهودِ ولا فِي العيانِ، بلْ يتحققُ بشهودِ وحدةِ الوجودِ، فيعلم حينئذٍ أنَّ وجودَ جميعِ الموجوداتِ هوَ عينُ وجودِ الحقِّ، فمَا ثمَّ وجدان بلْ الموجودُ واحدٌ، وَحقيقةُ الفناءِ عندَهم أنْ يفنَى عمَّا لا حقيقةَ لَه، بلْ هوَ وهمٌ وَخيالٌ، فيفنَى عمَّا هوَ فانٍ فِي نفسِه لَا وجودَ لَه، فيشهدَ فناءَ وجودِ كلِّ ما سواه فِي وجودِه، وَهذا تعبيرٌ محضٌ، وَإلا ففِي الحقيقةِ ليسَ عندَ القومِ سوى وَلا غيرٌ وإنِّمَا السوى والغيرُ في الوهمِ وَالخيالِ)([4]).
وَوَصَفَ الباحثُ محمود القاسم الفناءَ الصوفيَّ بقولِه: (الخلاصةُ: الفناءُ هوَ الجذبةُ، أوْ ما يحصلُ أثناءَ الجذبةِ، مِنْ غيبوبةٍ عنْ الخلقِ، وَهذَا هوَ الفناءُ عنْ الخلقِ، أوْ ما يحصلُ منْ غيبوبةٍ يتوهمونَها أنَّها فِي الحقِّ ويسمونَها: الفناء فِي اللهِ، وَهيَ شعورُ المجذوبِ بالألوهيةِ)([5]).
وَأمَّا بالنسبةِ لأقوالِ شيوخِ الصوفيةِ التي تشهدُ على قولِهم بوحدةِ الوجودِ وَاعتقادِهم بِها فهيَ كثيرةٌ جدًّا، أذكُرُ منها طائفةً متنوعةً في سبعِ مجموعاتٍ:
المجموعةُ الأولى: تتضمنُ أقوالًا لجماعةٍ منْ أوائل شيوخِ الصوفيةِ:
أولها: قولٌ لسهلِ بنِ عبدِ اللهِ التستري مفادُه: (يا مسكين، كانَ وَلَمْ تَكُنْ، وَيَكُونُ وَلَا تَكونُ، فلمَّا كُنْتَ اليومَ صِرْتَ تقولُ: أنَا وَأنَا، كُنْ الآنَ كَمَا لَمْ تَكُنْ، فإنَّه اليومَ كَمَا كانَ)([6]).
وقولُه هذا تضمنَ أمرين أساسيين؛ الأول: دعوةُ التستري إلى الفناءِ فِي اللهِ (كُنْ الآنَ كَمَا لَمْ تَكُنْ)، لينمحي الصوفيُّ وَيزول وَيسْتَشْعِر الألوهيةَ حسبَ زعمِ الصوفيةِ، وَالأمرِ الثاني: تقريرُ عقيدةِ وحدةِ الوجودِ (كَانَ وَلَمْ تَكُنْ، وَإنَّه اليومَ كَمَا كَانَ)، وَخُلاصةُ كلامِه أنَّه لا موجودَ إلا الله، وَالكونُ هوَ اللهُ([7]).
القولُ الثاني: هوَ أيضًا للتستري، (قالَ أبو نعيم الأصبهاني: قالَ عبدُ اللهِ بن شاذان: سَمِعْتُ ابنَ سالم يقولُ: سُئِلَ سهلُ بن عبدِ اللهِ عنْ سِرِّ النفسِ؛ فقالَ: للنفسِ سِرٌّ، مَا ظَهَرَ ذلكَ السرُّ على أحدٍ منْ خلقِه إلا على فرعونَ، فقالَ: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24]، وَلَها سبعُ حُجُبٍ سماويةٍ، وَسَبعُ حُجُبٍ أرضيةٍ، فكُلَّمَا يدفنُ العبدُ نفسَه أرضًا؛ سَمَا قلبُه سماءً، فإذا دَفَنْتَ النَّفسَ تحتَ الثرى وَصَلَ القلبُ إلى العرشِ)([8]).
أقولُ: واضحٌ منْ كلامِه أنَّ سِرَّ النفسِ عندَه هوَ أنَّها هيَ الربُّ، وَمَا ظهرَ إلَّا على فرعونَ الذي صرَّحَ بأنَّه الربُّ الأعلى، فحسب زعمِ التستري أنَّ حقيقةَ النفسِ أنَّها هي اللهُ!! وَهذَا قولٌ يندرجُ ضمنَ القولِ بوحدةِ الوجودِ؛ وَلهذَا جعلَ التستريُّ كلامَ فرعونَ سرًّا، وَأقرَّه عليه وَنوَّه بِه.
علمًا بأنَّ التستري قرَّرَ هنا موقفَ التصوفِ في قولِه بوحدةِ الوجودِ، وَلمْ يقرِّرْ الحكمَ الشرعيَّ منْ قولِ فرعونَ وَحقيقةَ النفسِ وسرَّها، وَلهذَا أقرَّ قولَ فرعونَ وقرَّرَ ما يخالفُ الشرعَ الذي ذمَّ فرعونَ وحكمَ عليه بالكفرِ والضلالِ والهلاكِ منْ جهةٍ، وَبَيَّنَ لنا أصلَ النفسِ البشريةِ وَسرَّها وَوظيفتَها منْ جهةٍ أخرى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 172].
وَقالَ تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
وَعَن النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلم -: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ))([9])، فهذَا هوَ أصلُ النفسِ البشريةِ وَسرُّها، ثمَّ بعدَ ذلكَ جعلَ اللهُ تعالى فيهَا اتجاهين: الخَير، وَالشَّر، وَأعطَاها حريةَ التصرُّفِ، وَكلَّفَهَا بِحَمٍلِ الأمانةِ؛ قالَ سبحانه: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 7 - 10].
وَقالَ تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد: 10].
وَقالَ تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10].
فإنْ اتَّبَعَتْ طريقَ الخيرِ فازتْ وسعدتْ فِي الدنيا والأُخرَى، وَإنْ اتَّبَعَتْ طريقَ الشرِّ كانَ مصيرُها الجحيمَ حتى وَإنْ تمتَّعَتْ بالدنيا، فَسِرُّ النفسِ ليسَ أنها هيَ اللهُ كمَا زعمَ التستريُّ، وإنَّما سرُّها كمَا أخبرَنا به الشرعُ، لكنَّ الرجلَ شَهِدَ على نفسِه وتصوفِه بأنَّه يعتقدُ بأنَّ سرَّ النفسِ أنَّها هي اللهُ، وَهذا يندرجُ ضمنَ وِحدةِ الوجودِ.
وَالقولُ الثالثُ: لأبي عبدِ اللهِ يحيى بن الجلاء: (مَنْ حافظَ على الفرائضَ فِي أولِ مواقيتِها فهوَ عابدٌ، ومنْ رأى الأفعالَ كلَّها مِنَ اللهِ فهوَ مُوحِّدٌ لا يرى إلا واحدًا)([10]).
أقولُ: كلامُه هذا غيرُ صحيحٍ في معظمِه، وَيتضمنُ القولَ بوحدةِ الوجودِ، وفيه افتراءٌ على الشرعِ والعقلِ والعلمِ؛ لأنَّه:
أولًا: إنَّ العابدَ في دينِ الإسلامِ ليسَ هوَ فقط مَنْ حافظَ على الفرائضَ في أولِ مواقيتِها، وَإنَّما هوَ الذي يلتزمُ بالشرعِ في كلِّ أحوالِه بصدقٍ وَإخلاصٍ، قلبًا وَقالبًا.
وثانيًا: إنَّ الرجلَ قرَّرَ عقيدةَ وحدةِ الوجودِ - الفناء الصوفي -؛ فمَنْ يعتقدُ بأنَّ الأفعالَ الطبيعةَ وَالبشريةَ هيَ مِنْ أفعالِ اللهِ فهذا يعني أنَّها ليستْ مِنْ أفعالِ المخلوقاتِ، وَإنَّما هي من أفعالِ الخالقِ، وبما أنَّ الأمرَ كذلكَ فكلُّ ما يحدثُ وَنراه في الطبيعةِ مِنْ كائناتٍ هي نفسُها اللهُ بحكمِ أنَّها أفعالُه؛ لأنَّ الأفعالَ مرتبطةٌ بصاحبِها وَلا تنفصلُ عنه، وَإنَّما مفعولاتُه هيَ التي تنفصلُ عنه.
وَبما أنَّ الرجلَ قرَّرَ أنَّ كلَّ مَا في الطبيعةِ منْ كائناتٍ هيَ منْ أفعالِ اللهِ، فهي نفسُها اللهُ وَليستْ منْ مفعولاتِه وَمخلوقاتِه، وَالرجلُ أكَّدَ مَا قرَّرنَاه عندما قالَ: (فهوُ مُوَحِّدٌ لَا يرى إلَّا واحد)([11])، فلا موجودَ إلا الله، ولا وجودَ لكائنٍ آخر معه، وَهذه هي عقيدةُ الفناءِ الصوفيةِ التِي ينمحي فيها الصوفيُّ وَينفصلُ عن الكونَ وَنفسِه؛ ليصبحَ يستشعر أنَّه هوَ اللهُ.
وَثالثًا: إنَّ الرجلَ بنى قولَه بوحدةِ الوجودِ على مبدأٍ غيرِ صحيحٍ، وَمخالفٍ للشرعِ والعقلِ والعلمِ، عندما جعلَ الأفعالَ كلَّها منَ اللهِ؛ لأنَّ الأمرَ الثابتَ قطعًا وَالذي لا يصحُّ الشكُّ فيه، هوَ أنَّ الكائناتِ منها الخالقُ، وَالباقي مخلوقاتٌ وَلَا ثالثَ لَهَا، وَالأفعالَ الموجودةَ فِي الكونِ منها ما هوَ مِنْ نتائجَ وَآثارِ أفعالِ اللهِ تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [يس: 82]؛ كخلقِه للكونِ وَما فيه منْ مخلوقاتٍ، وَمنها ما هيَ منْ أفعالِ اللهِ كمخاطبتِه لأنبيائِه وَكُتبِه المُنَزَّلةِ عليهِم، وَمنها ما هيَ منْ أفعالِ البشرِ وَآثارِها في الأرضِ وَعلى الطبيعةِ.
وَعليه؛ فلا يصحُّ جعل أفعالِنا وَآثارِها منْ أفعالِ اللهِ، وَمَنْ يُلْحِقُها بها فهوَ إمَّا جاهلٌ لا يعي ما يقولُ، وَإمَّا أنه مريضٌ رُفِعَ عنه القلمُ، وَإمَّا أنه صاحبُ هوى مغالطٌ سفسطائي، قالَ بذلكَ لغاياتٍ فِي نفسِه.
وَبُناءً على ذلكَ؛ فلا يمكنُ أنْ تكونَ الأفعالُ كلُّها مِنَ الخالقِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى خَلَقَنَا وَجعلَ فينا القدرةَ على الفعلِ، وَهدانا النجدين، ثمَّ كلَّفَنَا بعبادتِه؛ وَعليه فنحنُ مِنْ مخلوقاتِه وَمفعولاتِه، وَليستْ أعمالنُا وَأفعالنُا مِنْ أفعالِه وَإنَّما هي منَّا نحنُ؛ وَلهذا قالَ سبحانه: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 43].
وَقالَ تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [التوبة: 105].
وَقالَ تعالى: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } [غافر: 17].
وَقالَ تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
وَقالَ تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10].
عِلمًا بأنَّ دخولَ أفعالِ البشرِ وَكلِّ مَا يحدثُ في الكونِ في علمِ اللهِ تعالى وَقدرتِه وَقضائِه وَمشيئتِه لَا دخلَ له أبدًا في نفيِ حقيقةِ أنَّ أعمالَ البشرِ هيَ منِ أفعالِهم لَا منْ أفعالِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ سَبْقَ العلمِ بِهَا، لا ينفي صدورَها عن الناسِ وَمسئوليتَهم عنْها.
وَحتَّى عندما يكونُ العابدُ الملتزمُ بالشرعِ في حالةِ وُجدٍ وَخشوعٍ وَعاطفةٍ إيمانيةٍ عاليةٍ، فإنَّ هذه الحالةَ لا تنفي أفعالَه وَلَا تجعلُه يفقدُ التمييزَ بينَه وَبينَ خالِقِه، بدليلِ الصفاتِ الإيمانيةِ التي وَصَفَ بها اللهُ تعالى عبادَه المؤمنين، وَبِما كانَ عليه نبيُّنا - صلى اللهُ عليه وسلم - وَصحابتُه الكرامُ مِنْ إيمانٍ وَثباتٍ، وَصدقٍ وَإخلاصٍ، وَجمعٍ بينَ أعمالِ القلوبِ وَالجوارح.
لكنْ قَدْ يحدثُ خِلاف مَا ذكرناه عندما تكونُ العبادةُ مبنيةً على الأهواءِ وَالوساوسِ وَالتلبيساتِ الشيطانيةِ، وَحالاتِ التوهمِ وَالهلوسةِ بسببِ انحرافِ العابدِ عن الشرعِ، وَلِمَا هو فيه مِنْ شِدَّةِ الجوعِ وَالنعاسِ، وَفِي هذه الحالةِ يُلَبِّسُ عليه الشيطانُ أحوالَه وَيجعلُه يتوهمُ أمورًا لا حقيقةَ لها، كأنْ يجعله يحسُّ بأنَّه هوَ الله، وَمَع هذا فإنَّه عندَما يفيق سيعودُ إلى وعيِه وَيدركُ يقينًا أنَّه كانَ مخطئًا مريضًا مُلَبَّسًا عليه.
القولُ الرابعُ: هوَ أيضًا لأبي عبدِ اللهِ يحيى بن الجلاء، قالَ القشيريُّ: (سَمِعْتُ أبا حاتم السجستاني يقولُ: سمعتُ أبا نصرٍ السراج يقولُ: سُئِلَ ابنُ الجلاء: ما معنى قولِهم "صوفي"؟ فقالَ: ليسَ نعرفُه في شرطِ العلمِ، وَلكنْ نعرفُ أنَّ منْ كانَ فقيرًا مجردًا منَ الأسبابِ، وَكانَ معَ اللهِ تعالى بِلا مكانٍ، وَلا يمنعُه الحقُّ سبحانَه عنْ علمِ كلِّ مكانٍ يُسمى صوفيًّا)([12]).
وَقولُه يتضمنُ القولَ بوحدةِ الوجودِ، وَأنَّ القولَ بها غايةُ الصوفيِّ النهائيةُ، وَالرجلُ عبَّرَ عنها بالإشارةِ لا بالعبارةِ حسبَ مصطلحِ الصوفيةِ؛ لأنَّ مَنْ ليسَ له أفعالٌ وَلا مكانٌ يعني أنَّه قَدْ انمحى مِنَ الوجودِ وَزالتْ صفاتُه وَذاتُه، وَأصبحَ معدومًا ككائنٍ مستقلٍّ بذاتِه، وَفنيَ في اللهِ في علاقتِه بِه.
فيصبحُ الصوفيُّ هوَ اللهُ، وَاللهُ هوَ الصوفيُّ، وَهذا قولٌ بوحدةِ الوجودِ؛ لأنَّ الصوفيَّ في هذِه الحالةِ يشعرُ بداخلِه أنَّه هوَ اللهُ، وَأنَّ كلَّ مظاهرَ الطبيعةِ هي مجردُ أشباحٍ لَه، فاللهُ هو الكونُ، وَالكونُ هوَ اللهُ، فَلا موجودَ إلا هو حسب زعمِ الصوفيةِ.
وَالقولُ الخامسُ: لأبي إسحاق إبراهيمَ بن المولد الرقي كانَ يقولُ: (ثَمَنُ التصوفِ الفناءُ فيه، فإذا فنيَ فيه بقى بقاءَ الأبدِ؛ لأنَّ الفاني عنْ محبوبِه باقٍ بمشاهدةِ المطلوبِ وَذلك بقاء الأبدِ)([13]).
وَقولُه هذا يتضمنُ القولَ بوحدةِ الوجودِ، وَهوَ شاهدٌ على أنَّ غايةَ التصوفِ هي تحققُ الصوفيُّ بذلك، وَمعنى كلامِه أنَّ الصوفيَّ عندما ينمحي وَيزولُ بأفعالِه وَصفاتِه وَذاتِه ينقلُه فناؤُه إلى البقاءِ الأبدي، وَفيه يكتشفُ أنَّه هوَ الله حسب زعمِ الرجلِ.




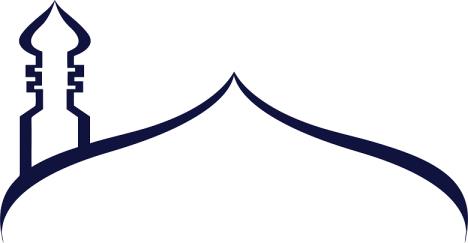







اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.