إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد؛....
فإن فاتحة القرآن إبحار في مقام التجريد والتفريد؛ تضع عنك أشكال البهتان، وألوان الكذب، وتذوب أغلفة الأوهام، والأماني المستحيلة، في نظرة الحق إلى ذاتك.
أنت الآن واقف تستفتح سفارك، تقدح تغريد الصلاة. أنت الآن كما أنت! أنت الآن أفقر ما تكون، وأطهر ما تكون، فقد نفضت يدك من كل الأثقال التي حملتها؛ مالا وولدا، ومنصبا ولقبا، فإنما الملك لله الواحد القهار، يا أيها الطيف العابر في مدار عابر.
وتحس بنعمة اليقظة، بين يدي عظمة الله سبحانه، وأعظم بها من نعمة، إذ كيف لذرة غابرة في ضخامة الكون الممتد في المجهول، وسعته الرهيبة، أن تحظى بالقرب ممن وسعت قدرته وعظمته سعة الكون وضخامته؛ خلقا وتقديرًا، وعلما وتدبيرًأ؟ لولا أن رحمته وسعت ما وسعت قدرته وعظمته تعالى؛ وهو بكل شيء محيط {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186].
ليس لهذه النفس المطمئنة الساعة إلا أن ترسل عبرات الفرح بالله، فتمد أغصانها المورقة حمدًا، وثناء، وتمجيدًا، وتفويضًا، مستزيدة بذلك من كرم الله ونعمه.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]: إعلام بشعور النفس الواقفة بمحراب الصلاة على عتبة الرحمن – بأن كمال الحمد إنما هو لسيد هذه العوالم جميعًا، تجريدًا لسواه تعالى عن كل ملكية، لأن نعمة أو منحة أو عطاء؛ وتفريدًا له – وهو سيد المخلوقات في العالمين – بوحدانية الألوهية والربوبية، وما تقتضيه من كرم فياض {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا} [الإسراء: 100]، فمن ذا يستحق الحمد من دونه تعالى؟!
ألا الحمد كل الحمد لله رب العالمين
كانت الكلمات – وهي من الله نزلت – تفيض من قلب العبد ريانة بشعوره الغيداق، المشوق برضى سيده الكريم، ويلقاها سبحانه بالقبول؛ فتنفتح سرورًا بين ضلوع العبد، وهو يشعر بجواب سيده، أندى، وأكرم، وألطف، وأحلم.. هذا مقام المناجاة: تقف فيه الذات المستجيرة بجوار الله، فيجيبها بإلقاء نور السلام، على خفقان غصنها، المضطرب بين خوف ورجاء، فإذا الطمأنينة تنفتح أمامها سهول إخبات فسيحة، ينال العبد فيها ما يشاء.
كان الشعاع الأخضر القادم من المقام النبوي؛ يلقي إلى النفس تفاصيل مناجاة النور:
"قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل:
فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2].
قال الله تعالى: حمدني عبدي.
وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3].
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي.
وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]
قال : مجدني عبدي.
فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].
قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7].
قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل"[1].
فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2].
قال الله تعالى: حمدني عبدي.
وإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3].
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي.
وإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]
قال : مجدني عبدي.
فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].
قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7].
قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل"[1].
فأي كرم هذا، وأي نعماء؟
سورة الفاتحة في غير الصلاة، تفتح للقارئ نافذة علم، إذ تلخص قصة الإسلام كلها، عقيدة وشريعة، والمفسر يكتسب بها مقام علم رفيع، وأما الفاتحة داخل محراب الصلاة، فهي تفتح للعابد أقواسًا من نور، لمشاهدة جمال العلم بالإسلام، من داخل قباب التعبد، فالعبد يقرأ بين يدي سيدي مناجيا، وشهود الحي القيوم حي بقلبه.
أنت إذن تقرأ: فترحل متجردًا من أثقال الطين، إلى ذوق لذة التعبد في حضرة المعبود، فتحس بأن الحال غير الحال، وأن وهج النور أقوى من أن يبصره بصر، فتمد قدح القلب؛ لتنال من رحمة الله مرتلًا:
{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3] فتكاد تعطف هذا الغصن، المتجرد في حضرة سيده، لولا أن المقام لما يحن بعدًا فيزداد شوقك إلى موضع سجودك، وترمقه بعينين خاشعتين، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض"[2].
وما زال نور الحمد يسرى في الفؤاد شوقًا ومحبة، فتحمده تعالى؛ تعظيما لألوهيته وربوبيته، وثناء على رحمته... رشفة أخرى من نور السورة؛ كافية بأن تفتح قلبك للنظر إلى عدل الله، المنبثق من رحمته، فتتوجه إليه سبحانه؛ تمجيدًا لملكه، وتفويضًا كل أثقالك إلى حكمه، ثم تسري السورة في أشواقك موجة أخرى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4] فترتفع حالك أنسًا، وترتقي محبة في مقام المعرفة بالله، أو ليس ذلك يوم الدين؟ اليوم الحق الذي تتبخر عند حافته أزمنة الغرور والأوهام؟
فما ملك ملوك الأحلام، إذا استيقظوا على حقيقة اليوم الحق، وهم ماثلون أمام الملك الحق؟ تلك صورة يتذوقها العبد، وهو يرشف – في صلاته – من فاتحة الكتاب، فيحس برهبة ذلك اليوم، الذي يعتلي فيه الرحمن عرش القضاء بين عباده، فتنبت مشاعر الحاجة الملحة إلى الاستزادة من رحمته تعالى؛ رهبا ورغبا؛ اتقاء لحرج يوم الحساب، الذي لا تغادر فيه صغيرة، ولا كبيرة؛ إلا أن يعفو الله؛ ويشعر المؤمن بضرورة العودة إلى ذاته لتمحيصها، وأول ما يمحصه؛ هذا الذي هو فيه الآن؛ صلاته القائمة، فليمعن في تجريد أعماقه من دسائس إبليس، مهما دقت؛ تفريدًا لوجه الله؛ المقصود وحده بالتعبد والاستعانة، فتفيض الحروف من قرار وجل حزين؛ ألا يكون المقال على وقع الفعال؛ وترسل الحنجرة تغريدها: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].
ويقول مولاك: "هذا بيني وبين عبدي"[3].
آه منك يا نفس؛ أي حق عليك لله عزوجل، وأي تبعه عليك، وأنت شاردة في متاهات اللهو، تبنين قصور الوهم في دار الخراب.
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ذلك بينك وبين العليم الخبير، فهو بعلمه سبحانه سيتولي تمحيص آثار ذلك في القلوب والجوارح... فيا أيتها الأغصان العابثة بين ربيع وخريف، تبيحين نداك لكل ريح؛ هذه الشمس تكاد تأتي على امتصاص كل أنداء الحياة، فإذا نضارة العود الطافح أوراقا وأزهارًا، تستحيل حطبا، يتحطم وهنا على أعتاب الآخرة، فأين أنت من {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [الفاتحة: 5]؟
كان الحزن الصاعد من الأعماق يتشكل في أفق المحراب بارقة مضطربة، بين جناحي قلب السالك، خفقا يحدوه مقام الخوف والرجاء، فترتفع الأشواق إلى بارئها؛ مستغيثة وملبية، تلهج بمعاني الحمد والثناء، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. وتنفلق الظلمات بومضة برق صارمة، فيشتعل الخوف بغصونك اشتعالًا، يكاد يحرق ما بقى بأندائها من رجاء، فتتعلق بأعمدة النور العلوي، و...وتبكي... مناديا {ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين}.
...... وتنهمر الأمطار.
ها هو الشاطئ أجمل ما يكون، وها هو ذا أنت أسقم ما تكون، وتمد يدك إلى شجر اليقطين، تمسح جروحك وتستر ضعفك، ثم تتقدم هونا في الطريق، وقد أورق رجاؤك ألطافا من روح الله، واشتد عطشك إلى نور الهداية، المسدد لخطواتك إلى الله؛ فجد الرجاء، وناجيت مولاك خاشعًا، راسمًا مبتغاك، وأنت ذرة تشق طريقها، في قصة تاريخ الإنسان مع الأديان:
{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7] آمين.
فالهداية إذن هي النور العاصم من الشرود في التيه؛ الضارب بعيدًا عن منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، فأهل العبادة والاستعانة بالله عليها، هم المنعم عليهم دون سواهم، وهم الذين عرفوا الحق فالتزموه، وتلك أم النعم، وذاك هو الصراط المستقيم، الذي زاغ عنه من عرف الحق وعمل بخلافه؛ فغضب الله عليه، ومن جهل الحق ولم يهتد إليه؛ فضل ضلالا بعيدًا.
كانت الفاتحة نقلة روحية كبرى، ارتقت بك من مقام إلى مقام، مما يلي أبواب عالم الدخن والفناء، إلى ما يلي أبواب عالم الصفاء والبقاء.
وتحس بجمال اللحظة، وأنت تجد فيها من معاني الخلود ما تجد، ويقوي رجاؤك في الله؛ أن يصفي دمعك من رائحة الطين، أتدري ما صفاء الدمع من رائحة الطين؟ ذلك حين تشف هذه الضلوع الصلبة عن يقين الوجدان الفوار بقلبك؛ ويترقرق الغدير في بطحاء الحب، فترى لآلئه الجميلة صافية الأديم، لا تضام في رؤيتها شيئًا، حين ذاك يصدق في حقك الوعد: "هذا لعبدي... ولعبدي ما سأل"[4].
ألا ما أعظمه من دعاء، وما أكرمه من عطاء.
كانت نهاية السورة تتفتح شعورًا قويا في القلب، بالإلحاح في الدعاء، فتفيض أنوار الهداية النبوية، بخاتةم من أمل أخضر يمتد صداه امتداد النفس الولهان، فإذا (التأمين) قنديل آخر، يجمع خفقات المحبين في السماء والأرض.
ألا تنظر إلى حلقة النور وهي تشكل هالة إصغاء، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يوقد ألوان القناديل؟
"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"[5].
سادتي...
صلوا على محمد.
صلوا على محمد.
الهوامش:
[1] رواه مسلم، رقم: (395).
[4] رواه مسلم، رقم: (395).
[5] رواه مسلم، رقم: (410).








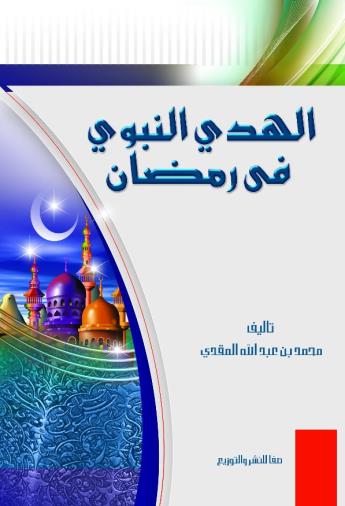
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.