خلقَ المولى سبحانه في النفسِ البشريةِ خطوطًا متقابلةً تؤدي مهمتُها في ربطِ الكائنِ البشري بالحياةِ، وَصفاتٍ فطريةً تحقِّقُ للإنسانِ كيانًا فريدًا متميزًا عنْ باقي المخلوقاتِ، ومنها صفتا الخوفِ وَالرجاءِ، وَاللتان تحددان مشاعرَ الإنسانِ وَاتجاهاتِه، وَأهدافَه وَسلوكَه وَأفكارَه، فعلى قدرِ ما يخافُ ونوعِ ما يخافُ، وعلى قدرِ ما يرجو وَنوعِ ما يرجو؛ يتخذُ لنفسِه منهجَ حياتِه، وَيوفِّقُ بينَ سلوكِه وبينَ ما يخافُ([1]).
وَالمنهجُ الإسلامي في التزكيةِ يمسكُ بزمامِ النفسِ البشريةِ منْ هذين الخطين المتقابلين، ويربطُ بهما توجيهاتِه وَأوامرَه وَنواهيه حتى تتلازمَ في أعماقِ النفسِ، وهذا مما يُعْرَفُ باسمِ الترغيبِ وَالترهيبِ([2]).
ولقدْ حفلتْ الآياتُ القرآنيةُ وَالأحاديثُ النبويةُ بالحضِّ على الطاعاتِ وَالتحذيرِ منَ المنكراتِ عنْ طريقِ الترغيبِ وَالترهيبِ؛ لكي تنقادَ النفسُ وَتنزجرَ وَتسارعَ إلى ما فيه مرضاةُ اللهِ سبحانه، مع بيانِ أهميةِ الخوفِ وَالرجاءِ فِي حياةِ المسلمِ وَآثارِهما في تقويمِ سلوكِه.
ومنْ ذلكَ قولُ الحقِّ سبحانه: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 9، 10].
وَقولُه تعالى: {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [الزمر: 15 - 21].
وهكذا تتوالى مشاهدُ الترغيبِ وَالترهيبِ في هذه الآياتِ الكريمةِ، الترغيبُ وَالبشارةُ لمنْ استقامَ على طاعةِ اللهِ، والنذيرُ والوعيدُ والتخويفُ الشديدُ لمنْ أعرضَ عنْ هدي الإسلامِ وحادَ عن الطريقِ المستقيمِ.
والمُتَأَمِّلُ لهذه الآياتِ الكريمةِ لابدَّ أنْ تهتزَّ أعماقُ نفسِه وَتتيقظَ فطرتُه وهو يرى هذا التقابلَ بينَ مَشَاهِدَ النعيمِ المُقيمِ لأهلِ الجنةِ، وما فيها منْ غرفٍ منْ فوقِها غرفٌ مبنيةٌ، وَمشاهدَ الشقاءِ والعذابِ لأهلِ النارِ وهمْ يحترقون في طياتِ تلكَ الظُّلَلِ المعتمةِ منْ فوقِهم وَمنْ تحتِهم([3]).
ومهما ترقَّى العبدُ في مدارج التقوى وَالعملِ الصالحِ فإنَّ نفسَه لا تستغني عن الترغيبِ والترهيبِ، ولا تستقيمُ بدون الخوفِ والرجاءِ، وهذا ما أرشدَ إليه المولى – سبحانه - في قولِه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 57 -61].
وقدْ روى الترمذي عنْ عائشة - رضيَ اللهُ عنها - قالتْ: ((سألتُ رسولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - عن هذه الآيةِ: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} قالتْ عائشةُ: هُمْ الذين يشربونَ الخمرَ وَيسرقون؟ قَالَ: لا يا بنتَ الصدِّيقِ، وَلكنَّهم الذين يصومونَ وَيُصَلُّون وَيَتَصَدَّقُونَ، وهم يخافونَ أنْ لا يُقْبَلَ منهم، أولئكَ يسارعونَ فِي الخيراتِ))([4]).
فهؤلاء العبادُ الصالحون الذين أثنى عليهم المولى سبحانَه، هم الذين يُعْطُونَ العطاءِ لمستحقِّيه ويقومون بأعمالِ البرِّ والطاعةِ، وهمْ خائفون وَجِلُونَ أن لا يُتَقَبَّلَ منهم؛ إشفاقًا مما قدْ يعتريهم منْ تقصيرٍ، ولذلكَ جعلَهم اللهُ مِنَ السابقين؛ لكونِهم جمعوا بينَ إحسانِ العملِ وَالخشيةِ مِنَ المولى سبحانه، فهم مع إحسانِهم مُشْفِقُون خائفون([5]).
كمَا قَالَ الحسنُ البصري - رحمهُ اللهُ -: (عَمِلُوا وَاللهِ بالطاعاتِ، وَاجتهدُوا فيها، وَخَافُوا أنْ تُرَدَّ عليهم، إنَّ المؤمنَ جَمَعَ إحسانًا وَخشيةً، والمنافقُ جَمَعَ إساءةً وَأمنًا)([6]).
كَمَا أثنَى اللهُ سبحانه على عبادِه الصالحين عمومًا؛ فقدْ أثنى على أنبيائِه وَرسلِه - عليهم السلام - بأنهم كانوا يتقرَّبون إلى ربِّهم، ويدعونه رَغَبًا وَرَهَبًا، فيجعلونَ الرغبةَ وَالرهبةَ متلازميتين، وفي ذلك يقولُ الحَقُّ - عَزَّ وجل -: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90].
وَبعدَ استعراضِ جانبٍ يسيرٍ مما حَفِلَتْ به آياتُ القرآنِ الكريمِ منْ بيانِ أهميةِ الترغيبِ وَالترهيبِ، وتوجيهِ العبادِ لما فيه صلاحُهم بالرغبةِ وَالرهبةِ، ننتقلُ إلى الأحاديثَ النبويةِ لنستعرضَ بعضَ ما وردَ منها في هذا المجالِ، ولندركَ أهميةَ الترغيبِ والترهيب ِوآثارَهما في تزكيةِ النفسِ وإصلاحِ السلوكِ.
فقدْ روى مسلمٌ عنْ أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - قالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِندَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ مَا طَمعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكافرُ مَا عِندَ اللهِ مِنَ الرحمةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ))([7]).
وفي هذا تنبيهٌ للمؤمنِ، أنْ لا يغترَّ بالرجاءِ وَيتركَ الخوفَ فيدْعُوه ذلكَ إلى التكاسلِ عَن الطاعاتِ، وفيه ترغيبٌ للكافرِ أنْ يبادرَ إلى الإيمانِ، وأنْ لا يقنطَ مِنْ رحمةِ اللهِ سبحانه مهما بدرَ منه، فالإيمانُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَلَعَلَّ هذه الومضةَ منَ الرجاءَ تنيرُ قلبَه وتكونُ سببًا في هدايتِه.
عنْ أبي هريرة - رضيَ اللهُ عنه - قالَ: ((سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - يقولُ: مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ، ألَا إِنَّ سلعةَ اللهِ غاليةٌ، ألَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهَ الجنَّةُ))([8]).
وَهذا الحديثُ دليلٌ واضحٌ على دورٍ الترهيبٍ في تزكيةٍ النفسٍ وتقويمٍ اعوجاجٍها، فمنْ خافَ الليلَ الحالكَ في المكانِ المُوحشِ أسرعَ السيرَ منْ أولِ الليل ليدركَ مَأْمَنَهُ، ولوْ أنَّه تباطأَ وتقاعسَ لَحَلَّتْ بِه الندامةُ، واجتمعتْ عليه المخاوفُ، وَاتشدتْ ظلمةُ الليلِ فلمْ يَعُدْ يستطيعُ المسيرَ.
وكذلكَ العبدُ المُوَفَّقُ الذي يسيرُ في طريقِ الآخرةِ، ينبغي عليه أنْ يستحثَّ الخُطَا ليبلغَ منزلَه في الجنةِ، وأنْ يهربَ منَ المعاصي، وَيحذرَ منْ مكائد الشيطانِ، ويجاهدَ نفسَه على طاعةِ اللهِ، ليحظى بالجنةِ التي هي غايةُ الثمنِ، ولا تُنَالُ إلا بالجهدِ والبذلِ ودوامِ الخشيةِ منَ المولى سبحانه.
عن أنس - رضيَ اللهُ عنه - قالَ: ((بَلَغَ رسولَ اللَّه - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - عَنْ أَصْحابِهِ شَيءٌ فَخَطَبَ، فَقَالَ: عُرضَتْ عَلَيَّ الجنَّةُ والنَّارُ، فَلَمْ أَر كَاليَوْمِ في الخَيْر وَالشَّرِّ، ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعلَمُ لَضحِكْتُمْ قلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً.
فَما أتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - يوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ غَطَّوْا رُؤُسهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ، قالَ: فقالَ عمرُ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيًّا))([9]).
وقدْ جاءتْ هذه الموعظةُ البليغةُ منَ الرسولِ - صلى اللهُ عليه وسلم - تعقيبًا على ما بَلَغَهُ عن بعضِ أصحابِه مما لا ينبغي فعلُه؛ ولذلكَ اقتضى الأمرُ تغليبَ جانبِ الترهيبِ وَالتخويفِ، ليكونَ أسرعَ في التأثيرِ، وأبلغَ في تحريكِ النفسِ واتسجابتِها، فخطبَ - عليه الصلاةُ والسلامُ - هذه الخطبةَ التي ذَكَّرَ فيها بالجنةِ والنارِ، وخوَّفَ فيها منْ عذابِ الجبارِ سبحانه، حتى اشتدَّ بكاءُ الصحابةِ - رضيَ اللهُ عنهم -.
وقدْ كانَ الرسولُ المُرَبِّي - صلى اللهُ عليه وسلم - في غايةِ الحرصِ على تزكيةِ نفوسِ أصحابِه وتقويمِ سلوكِهم بما يُرْضِي اللهَ سبحانه، وَكانتْ مواعظُه ووصاياه وَإرشاداتُه تأخذُ بمجامع القلوبِ، وَتُحْيِي النفوسَ، حتى بلغَ الصحابةُ - رضيَ اللهُ عنهم - هذا المبلغَ العظيمَ مِنَ الالتزامِ بالإسلامِ وَإخلاصِ العملِ للهِ – سبحانه - وبذل النفسِ فِي سبيلِه.
وقدْ حفلتْ كتبُ الحديثِ النبوي بمواعظه - صلى اللهُ عليه وسلم - وإرشادتِه التي تجمعُ بينَ الترغيبِ والترهيبِ، والخوفِ والرجاءِ، وتجعلُ منهما مرتكزًا للتأثيرِ في النفسِ.
ومنْ ذلكَ ما رواه الترمذي عَنْ أبي نجيح العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رضيَ اللهُ عنه – قَالَ: ((وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وذَرَفَتْ منهَا الْعْيُونُ، فقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأنَّها مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا؛ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمرعليكم عَبْدً، وإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فسيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))([10]).
وقدْ جاءتْ هذه الوصايا الجامعةُ بعدَ تلكَ الموعظةِ البليغةِ لتكونَ علاجًا حاسمًا لِمَا قدْ يعتري النفسَ مِنْ أمراضٍ، ودافعًا قويًّا إلى رُقِيِّهَا وَاستقامتِها على منهجِ الإسلامِ، ولقدْ ملأتْ تلكَ الموعظةُ قلوبَ الصحابةِ خشيةً مِنَ اللهِ، وَأسالتْ مدامعَ عيونِهم وَرَقَّتْ بنفوسِهم إلى العالمَِ الآخرِ؛ ولذلكَ سارعوا إلى طلبِ وصيةٍ يلتزمون بها؛ ليبقوا على عهدِهم مع الرسولِ - صلى اللهُ عليه وسلم - بعدَ وفاتِه.
وَلاشَكَّ أنَّ الترهيبَ وَالتخويفَ له أثرهُ البليغُ فِي تزكيةِ النفسِ وترقيقِ قسوةِ القلبِ، ولكن لابدَّ فيه منْ ميزانٍ دقيقٍ لِئَلَا يؤدي إلى اليأسِ مِنْ رحمةِ اللهِ سبحانه؛ يقولُ الإمامُ ابنُ القيمِ - رحمهُ اللهُ -: (الخوفُ المحمودُ الصادقُ مَا حَالَ بَيْنَ صاحبِه وَبَيْنَ محارمِ اللهِ - عزَّ وجل -، فإذا تجاوزَ ذلكَ خيفَ مِنَ اليأسِ وَالقنوطِ)([11]).
وَيقولُ في بيانِ منزلةِ الخوفِ وَالرجاءِ: (إِنَّ الخوفَ أحدُ أركانِ الإيمانِ والإحسانِ الثلاثةِ التي عليها مدارُ مقاماتِ السالكين جميعها، وهيَ الخوفُ وَالرجاءُ وَالمحبةُ، وقدْ ذكرَه سبحانه في قولِه: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 57]، فجمعَ بينَ المقاماتِ االثلاثةِ، فإنَّ الوسيلةَ إليه هي التقربُ إليه بِحُبِّه وَفِعْلِ ما يُحِبُّهُ)([12]).
وَيُنَبِّهُ - رحمهُ اللهِ - على ضرورةِ تغليبِ جانب الخوفِ على جانبِ الرجاءِ، وَبخاصة فِي حَالَةِ الصحةِ؛ فيقول: (القلبُ في سيرِه إلى اللهِ - عز وجل - بمنزلةِ الطائرِ، فالمحبةُ رأسُه، والخوفُ والرجاءُ جناحاه، فمتى سَلِمَ الرأسُ وَالجناحان فالطائرُ جيدُ الطيرانِ، ومتى قُطِعَ الرأسُ ماتَ الطائرُ، ومتى فُقِدَ الجناجان فهوَ عرضةٌ لكلِّ صائدٍ وكاسرٍ، ولكن السلفَ استحبُّوا أن يُقَوِّي فِي الصحةِ جناحَ الخوفِ على جناحِ الرجاءِ، وعندَ الخروجِ مِنَ الدنيا يُقَوِّي جناحَ الرجاءِ على جناحِ الخوفِ)([13]).
ولاشكَّ أنَّه لابدَّ منْ تغليبِ الخوفِ في الدعوةِ والمواعظ والخطبِ، وبخاصة فِي وقتِنا الحاضرِ الذي طغتْ فيه المادةُ على النفوسِ، وازدادَ الرجاءُ عندَ الناسِ حتى اغتروا بالأماني، ولا تعود تلك النفوسُ إلى استقامتِها إلا بالتخويفِ مِنْ عذابِ اللهِ سبحانه، وَالتذكيرِ بمشاهد القيامةِ وَأهوالِها، ولو كان أثرُها شديدًا على النفس.
وفي ذلكَ يقولُ الإمامُ ابنُ رجب الحنبلي - رحمهُ اللهٌ -: (المواعظُ سياطٌ تُضْرَبُ بها القلوبُ، فتؤثِّرَ في القلوبِ كتأثيرِ السياطِ في البدنِ، والضربُ لا يُؤثِّرُ بعدَ انقضائِه كتأثيرِه في حالِ وجودِه، لكن يبقى أثرَ التألمِ بحسبِ قوتِه وَضعفِه، فكُلَّمَا قوي الضربُ كانتْ مدةُ بقاءِ الألمِ أكثرَ)([14]).
وهكذا يُحَقِّقُ الترهيبُ وَالتخويفُ مِنْ عذابِ اللهِ دورَه فِي تزكيةِ النفسِ، فيحظى أهلُ الخشيةِ بالأمنِ يومَ الوعيدِ وَالفوزِ بالجنةِ يومَ الخلودِ.
وفي ذلك يقولُ الحقُّ سبحانه: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46].
الهوامش:









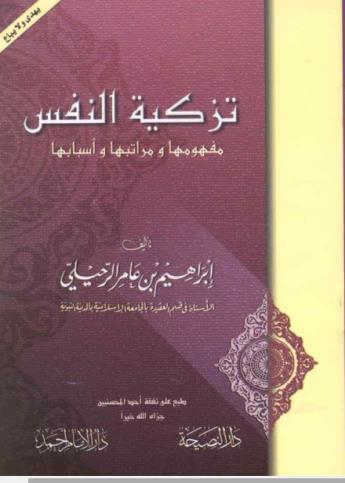

اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.